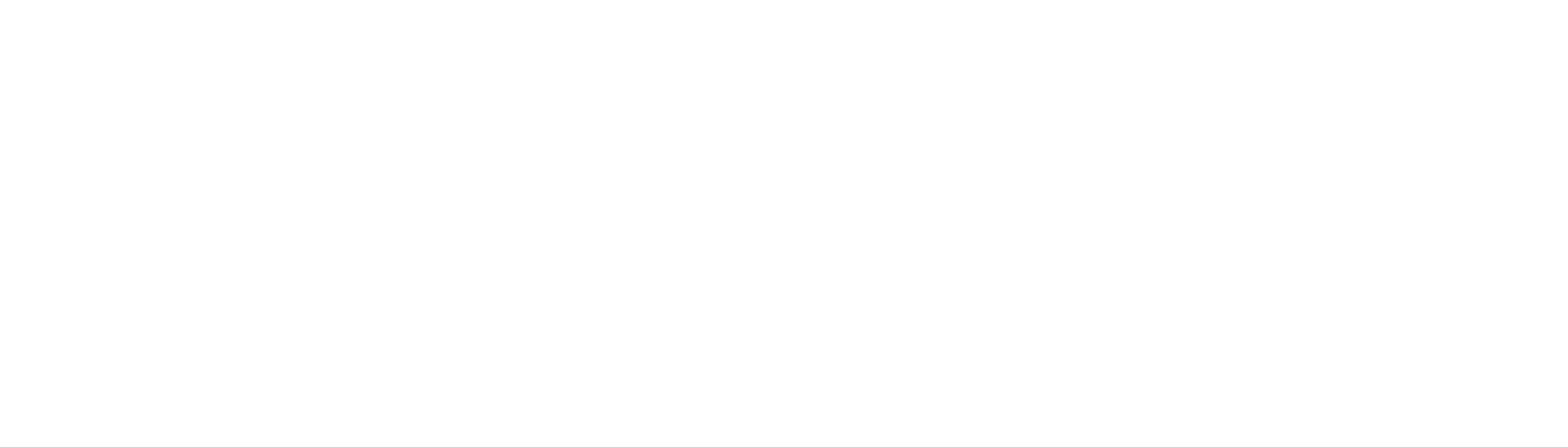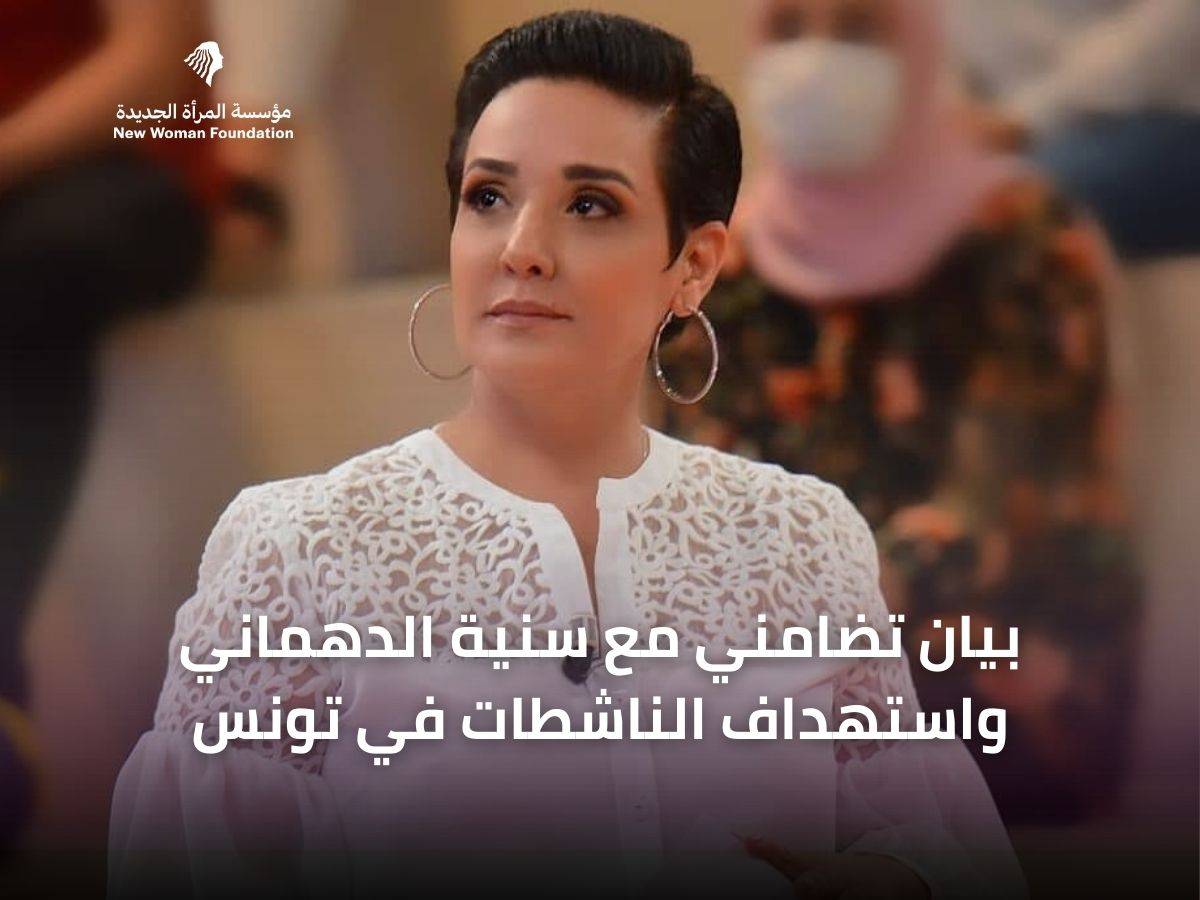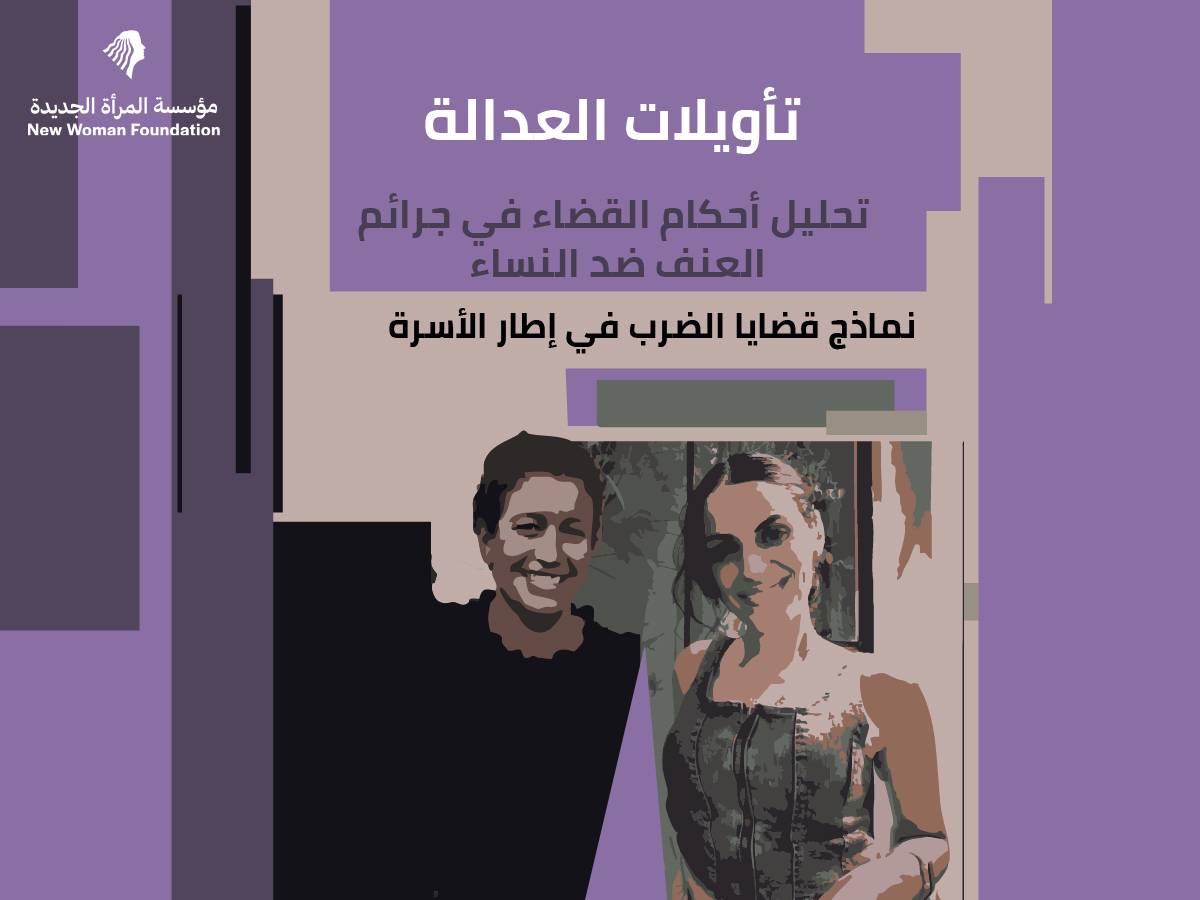- للتـــواصل مع المؤسســــة
- 0020233382706
- nwrc@nwrcegypt.org
بلاغ بلا عدالة.. هشاشة حماية النساء

تأويلات العدالة: تحليل أحكام القضاء في جرائم العنف ضد النساء .. نماذج قضايا الضرب في إطار الأسرة
يوليو 8, 2025
بيان تضامني مع سنية الدهماني واستهداف الناشطات في تونس
يوليو 12, 2025بلاغ بلا عدالة.. هشاشة حماية النساء
كتبت: منار عبد العزيز
ضمن عمل مكاتب مساندة الناجيات بمؤسسة المرأة الجديدة، حاول الفريق دعم فتاة قاصر تواجه عنفًا أسريًا.
تم إبلاغ الجهات الرسمية فورًا لتوفير الحماية اللازمة، لكن المفاجأة.. أن إحدى الموظفات هناك قامت بإبلاغ أسرة الفتاة مباشرةً بدلًا من اتخاذ أي إجراء فعلي يحفظ سلامتها. والنتيجة، تحوّلت إلى تهديد مباشر للفتاة، ولم يكن أمام الفريق سوى التفاوض مع الأسرة وتأمين بعض الضمانات لحمايتها من ظروف أكثر قسوة. ما حدث يعكس، رغم صعوبته، حظًا أفضل من مصائر فتيات أخريات، ويكشف اهتزاز الثقة في مؤسسات يُفترض أن تكون حامية للنساء والفتيات.
تتكرر هذه المشاهد مع نساء كثيرات يُردن الإبلاغ عم يتعرضن له، لكنهن يترددن تحت وطأة الخوف والتوتر. كثيرات قابلن التجاهل أو التهديد أو السخرية أو التشكيك في روايتهن، وهناك من رٌفض تحرير محاضر لهن أو تم تأجيلها عمدًا أو الضغط عليهن لتغيير أقوالهن أو التراجع عنها، بحجج الحفاظ على الأسرة أو “الحق في التأديب”.
وهنا، يصبح وجود محامٍ أو محامية خطوة لا بد منها لتقليل احتمالات الإيذاء الثانية، ولمدّ النساء بالشعور بالدعم الذي يفتقدنه عند اللجوء إلى منظومة العدالة الجنائية.
ما يحدث ليس تفاصيل عارضة، بل خللًا بنيويًا في تعامل مؤسسات العدالة مع بلاغات النساء والفتيات، خصوصًا في قضايا العنف داخل المجال الخاص. الإبلاغ، الذي يُفترض أن يكون بوابة للعدالة، يتحوّل كثيرًا إلى تجربة قاسية بحد ذاتها، تترك النساء في دائرة الخوف والوصم، وتفتح الباب لإعادة إيذائهن بدلًا من مساءلة الجناة.
من هذا الواقع، تنشأ مكاتب الدعم القانوني في المجتمع المدني كاستجابة لحاجة النساء إلى مساحة آمنة، تعينهن على فهم الواقع وتفكيك علاقات القوة في منظومة العدالة، وبناء بدائل قائمة على تجاربهن لا على نصوص قانونية جامدة. وفي ظل ما تُتيحه منصات التواصل الاجتماعي من مساحة للمشاركة، تستخدمها النساء وذويهن لدفع مؤسسات الدولة نحو اتخاذ إجراءات عادلة بحق الجناة، يبرز مفهوم “عدالة الإبلاغ” كمحاولة لفهم ليس فقط ما إذا كانت قنوات الإبلاغ متاحة، بل إن كانت عادلة ومنصفة وتستحق ثقة النساء في أن يُسمع صوتهن لا يُستهان به.
كسر الصمت وتحقيق التغيير
عدالة الإبلاغ -Whistleblowing، نشأ هذا المفهوم في الإطار المؤسسي بهدف حماية المُبلغين/ات عن الفساد المالي والإداري أو الانتهاكات من الانتقام أو التهديد، وتم وضع آليات تشجّع على الإبلاغ بدلًا من الصمت والتطبيع مع المخالفات.
في السياق النسوي، تطورت الأدبيات والمقاربات وأصبح الإبلاغ فعلًا جندريًا مقاومًا، ليس محايدًا، بل ممارسة سياسية تنكشف داخلها داخل تقاطعات وعلاقات النوع الاجتماعي والتراتبية الإدارية والمخاطر الشخصية. لا سيما حين يتعلق الأمر بموظفات تُبلغن عن انتهاكات جنسية أو تمييز نوعي داخل المؤسسات، وهنا تعتبر “عدالة الإبلاغ” ليست فقط آلية حماية، بل منظور يسعى إلى تغيير جذري في ثقافة المؤسسات وآليات مساءلتها.
وبتراكم الخبرات الحقوقية وصعود الموجات النسوية، تحولت تجارب الإبلاغ من تحرك فردي إلى حركة اجتماعية واسعة، وتعتبر حملة #MeToo نموذجًا واضحًا في هذه الحركة الجماعية من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لفضح العنف المنهجي الممارس ضد النساء في المجالين العام والخاص، وتحوّلت تجربة كسر الصمت عن الفساد والانتهاكات داخل المؤسسات إلى محاولة لكسر أيضًا موازين القوى المختلة التي تدفع النساء إلى الصمت عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرّضن لها ومقاومة بنية سلطوية أوسع، يُعاد فيها إنتاج العنف من خلال التواطؤ والتمييز والتقاعس والتشكيك في مصداقية النساء.
ولم تقف الحركات النسوية عند الرفض، بل تفاعلت مع هذه الموجة وبادرت المؤسسات بتأسيس منصات تشجع على الإبلاغ الآمن للنساء, وعلى فضح ووصم المتهمين بالعنف لا الناجيات منه، فتجربة كسر الصمت لم تعد فقط طريقًا إلى العدالة، بل أداة لتغيير معادلات السلطة ذاتها، ولفضح ثقافة مؤسسية تحتاج إلى مساءلة مستمرة، لا إلى شعارات عابرة. وراكمت على هذه الحملة أيضًا بالضغط من أجل إصلاح تشريعي من شأنه مواجهة جادة للعنف ضد النساء.
الناجيات في مواجهة حماية هشّة
رغم الاستراتيجيات الوطنية والتعديلات القانونية التي أعلنتها الدولة لمناهضة العنف ضد النساء في مصر، إلا أن واقع الإبلاغ بحسب تجارب تعرضت لها ووثقتها مقدمي/ات خدمات الدعم القانوني في مؤسسات المجتمع المدني، تكشف واقعًا مختلفًا، فهناك حالات متكررة لنساء وفتيات واجهن رفضًا مباشرًا من أقسام الشرطة لتحرير المحاضر، أو تعرّضن للابتزاز أو اللوم أو الوصم، أو طُلب منهن التنازل عن البلاغ من أجل التصالح مع الجناة أو خوفًا من أسرهن.
وبالإضافة إلى عدم توافر آليات واضحة لمساءلة القائمين على استقبال وتحرير البلاغات في حال التقاعس عن الاستجابة لبلاغات العنف. لا يمكن إغفال محور جوهري يتعلق بزيادة تكلفة اللجوء إلى منظومة التقاضي ووقعها على النساء في مدى استقلالية قرارهن وقدرتهن على تحمل هذه التكلفة الاقتصادية.
هذه الدلالات وغيرها بمثابة مؤشرات تكشف عن هشاشة مؤسسية وقانونية تعوق وصول النساء إلى العدالة، وتُضعف من فاعلية الإبلاغ كأداة للحماية والمساءلة، وهذا التراخي لا يحتاج فقط إلى تدخلات تقنية، بل هو هيكلي ومبني على تجاهل طويل المدى لمفاهيم الحماية الشاملة، والتصديق، والدعم متعدد المستويات: “القانوني، والنفسي، والاقتصادي والاجتماعي”.
وبالتالي، فإن محاولة تحسين فرص النساء في العدالة، ينبغي أن تتجاوز وجود مكاتب الشكاوى أو خطوط ساخنة أو وحدات نسائية، بل تسعى إلى بناء منظومة إبلاغ عادلة تتطلب مراجعة شاملة للسلوك المؤسسي والقوانين والثقافة الأمنية والأبوية.
تجارب من الجنوب العالمي
في بلدان الجنوب العالمي، هناك مساعي ربما تكون ملهمة للسياق المصري على صعيد المجتمع المدني أو مؤسسات العدالة الجنائية.
حاولت نيجيريا الاستفادة من إصدار قانون حماية المبغلين/ات، ضمن منظومة عدالة الإبلاغ عن المخالفات والفساد، في السعي نحو توسيع النطاق لمعالجة ثقافة الصمت وضعف الإبلاغ في جرائم العنف القائم على النوع من خلال حشد الدعم لاعتماد الإبلاغ، كذلك توفير منصة إبلاغ سرية لمن تعرّضن لوقائع عنف بمختلف أشكاله، لتشجع الناجيات أو ذويهن على الإبلاغ وتمكين الناجيات من الحصول على مساعدة الجهات المعنية، بالإضافة إلى الرعاية الطبية والدعم النفسي وتحقيق العدالة، مع الإسهام في حفظ السجلات الإحصائية وتحسين إدارة قضايا الجرائم القائمة على النوع في نيجيريا.
وفي جنوب أفريقيا، تم إنشاء مراكز للتعامل مع ضحايا الاعتداء الجنسي، تنتشر في المستشفيات والمراكز الصحية، وتهدف إلى تقديم خدمات متكاملة طبية، وقانونية، ونفسية، في مكان واحد بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة ومنها الشرطة، والنيابة، والإدارة الصحية، والحكومة والمجتمع المدني.
انتشرت هذه المراكز لتصل إلى 66 مركز في أنحاء البلاد، مقارنة بـ 55 مركز منذ عام 2021. وساهمت هذه المراكز في رفع معدلات الإبلاع لتصل إلى ما يقرب من 30,000 بلاغ في عامي 2020/2021، وصولًا إلى ما يقرب من 36,800 بلاغ في عامي 2022/2023، كما ساهمت في رفع معدلات الإدانة في هذه البلاغ من 60% في عام 2010 إلى حوالي 77.5% بنهاية 2023، ويتعلق الأمر بالخدمات المُقدمة التي تساعد الضحايا على اجتياز إجراءات المحكمة.
أما الأرجنتين، فأنشأت المحكمة العليا مكاتب للعنف الأسري، وتتكون من محامين، وأطباء، وأخصائيين نفسيين، لتقديم الدعم متعدد الأبعاد للناجيات من خلال استجابة الدولة الأولية. وبالرغم من ذلك، ظلت هناك إشكاليات في الإبلاغ، حتى خرجت الحركة النسوية ني أونا مينوس في 2015، بعد مقتل فتاة صغيرة كانت حاملًا بعدما تعرضت للضرب حتى الموت لإجبارها -من قبل شريكها- على تناول أدوية الإجهاض.
مرت هذه الحركة بموجات مختلفة من التظاهرات والإضراب العام النسائي، بيد أن هذه الحركة نجحت في توجيه مؤسسات الدولة نحو إنشاء السجل الرسمي للحاجة إلى شفافية في البيانات والإحصاءات، كذلك تأسيس وحدات تحقيق خاصة دخل النيابة والشرطة، حيث تتولى تلقي ومتابعة شكاوى العنف الجنسي، أيضًا ساهمت الحركة في دفع مؤسسات الدولة نحو تقديم خدمات مجانية للناجيات بما في ذلك تأسيس فرق محامين/ات ومرشدين/ات نفسييين/ات، بيد أن هذه الخطوات ما زالت تواجه كثير من التحديات، حيث أن الخدمات التي تقدمها الدولة غير منتظمة وغير موزعة بعدالة جغرافيًا نتيجة للبيروقراطية.
تكشف هذه التجارب، بالإضافة للوضع الراهن في مصر، أن الإبلاغ عن وقائع العنف ضد النساء ليس مجرد مسار قانوني، بل هو نقطة تماس هامة وكاشفة بين الناجيات والدولة، وبين الخوف واختيار الصمت أو المساءلة وإمكانية تحقيق العدالة.
وفي ظل هشاشة الأنظمة القانونية في توفير آليات حماية للناجيات ومساءلة الجناة، فإن مفهوم عدالة الإبلاغ يعد أداة تحليلية تسمح لنا بطرح الأسئلة حول من يملك القدرة على الإبلاغ، وأيضًا التساؤل حول ماهية الاستجابة والتفاعل مع الإبلاغ، ونوعية الإنصاف، ومسارات الحماية.
حق جماعي لا خيار فردي
ما تُبرزه هذه التجارب أن الإبلاغ عن العنف ليس مجرد خطوة قانونية، بل لحظة تماس بين الناجية والدولة، وبين الخوف والرغبة في العدالة. في واقع تعاني فيه الأنظمة من ضعف الحماية والمساءلة، يصبح مفهوم “عدالة الإبلاغ” أداة تحليل تُعيد طرح أسئلة جوهرية: من تملك/يملك القدرة على الإبلاغ؟ كيف تتجاوب الدولة؟ ما طبيعة الحماية والإنصاف المتاحة؟ وهل يثق الناس أصلًا بمنظومة العدالة؟
عدالة الإبلاغ، إذًا، ليست نهاية المطاف، بل انطلاقة نحو مسار أوسع من استعادة الحقوق والكرامة. هي حق جماعي، لا مجرد خيار فردي، وأحد مفاتيح العدالة الجندرية التي تضع الناجيات في قلب المسار لا في هامشه.
“بلاغ بلا عدالة.. هشاشة حماية النساء”.. مقال جديد نشارك به في حملة “عدالة الإبلاغ” بالتعاون مع منصة فكر تاني